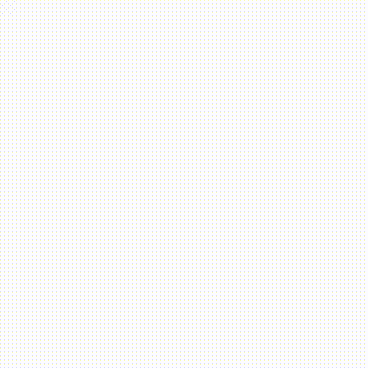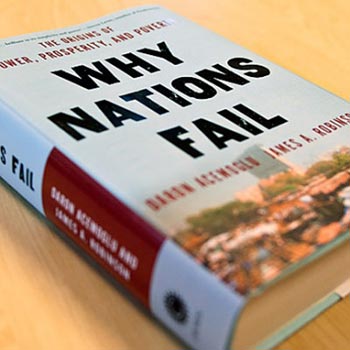العالم الاقتصادي- رصد
يتناول الكتاب بعض الأسئلة التي يمكن أن نطلق عليها “الأسئلة الكبرى”، حيث يتساءل: لماذا تزدهر مجتمعات بعينها بينما لا تتمكن مجتمعات أخرى من تحقيق ذلك؟، كيف يمكن تحسين طبقة فقيرة بشكل كامل؟، ثم لماذا تتحول بعض الأمم إلى
“Failedstartes”مجتمعات فاشلة.
يزعم كل من اكيموجلو وروبنسون أن المؤسسات هي التي تحدد مصائر الأمم، فالنجاح يأتي عندما تكون المؤسسات السياسية والاقتصادية “احتوائية” و”تعددية” بحيث تخلق دوافع لأفرادها جميعاً للعمل من أجل المستقبل، وتفشل الأمم عندما تكون “استبعادية”، تقوم بحماية الأصول السياسية والاقتصادية لنخبة ضيقة تنتفع من دخول باقي أفراد المجتمع.
يبدو مألوفاً بين العاملين في مجال التنمية أنهم دائماً ما يتمنون أن يكون في الحكم مجموعة من الخبراء التكنوقراط غير المسيسين، ويدعم الكاتب تلك الرؤية بقوله: إنه لتصل إلى حالة اقتصادية صحية لابد من أن تكون البيئة السياسية صحية وتعددية، يدعم ذلك تجارب الدول التي قامت وسقطت منذ العصور الوسطى نذكر منها “البندقية”، فترة احتلال أميركا، وصولاً إلى بتسوانا وما شهدته من نزاع قبلي إلى الاستقلال عام 1966 .
يعني لفظ “مؤسسات سياسية احتوائية” أمرين رئيسيين: الأول توزيع واسع للقوة السياسية على فئات المجتمع، والثاني هو وجود كوابح لهذه القوة، يتمثل في الانتخابات الديمقراطية والدساتير المكتوبة، وعادة ما تحفظ المؤسسات الاحتوائية حقوق الملكية، وتضمن تنافسية الأسواق، وحريات المواطنين في الدخول لصناعات ووظائف باختيارهم الحر، على سبيل المثال فإن رجل الأعمال والملياردير المكسيكي “كارلوس سليم” لا يعبر عن أي سياسات احتوائية، فهو عراب العقود الحصرية، حيث يتمكن من الحصول على احتكارات اقتصادية عبر شبكة علاقاته السياسية الضخمة، وفي النهاية تعود الأرباح لحسابه الشخصي وليس لحساب المكسيك كأمة، على الجانب الآخر فإن بيل جيتس قادر على إفادة نفسه وإفادة الولايات المتحدة الأميركية على السواء، ففي السوق التنافسية يتمكن جيتس من جني الأموال عن طريق إنتاج سلع أكثر تنافسية أو أكثر شعبية من منافسيه.
وكما تستفاد وتقوم المؤسسات الاحتوائية على بعضها بعضاً، فإن نظيراتها من الاستبعادية تفعل المثل، فالمؤسسات السياسية الاستبعادية دائماً ما تدعم المؤسسات الاقتصادية التي تحمي مصالح نخبة بعينها وتمنع دخول أي منافسين لها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، في المقابل فإن ثروة هذه النخبة تمكن الدولة السلطوية من الحفاظ على هيراريكيتها وتدعم قدرتها على مزيد من القمع، الذي بدوره يؤدي إلى مزيد من تمركز الثروة في أيدي هذه النخبة، هذه الدائرة الخبيثة تعني أن التاريخ السيئ يؤدي بالضرورة إلى حاضر سيئ.
إذا ما قارنا بين النمو الذي حققته دول أوروبا الغربية بالتعثر الذي تعانيه دول أوروبا الشرقية، نجد أن السبب تاريخي يعود إلى استمرار اعتماد دول أوروبا الشرقية على نظام العبودية في القرن التاسع عشر لفترة طويلة بعدما كانت أوروبا الغربية قطعت شوطاً كبيراً في منح العمال حقوقهم.
لقد كان الاستعمار الأوروبي استبعادياً حتى على الأوروبيين أنفسهم، فلقد سمح ببقاء مجموعات معينة من النخبة في المستعمرات الأوروبية وهم من حصلوا على الأرباح والمنافع، على الجانب الآخر فإن الوضع في أميركا الشمالية كان مختلفاً، لأن من بقي في المستعمرات هم أبناء الطبقة المتوسطة من الفلاحين في مقابل نخبة أوروبية في أميركا الجنوبية، وتنتج المؤسسات الاستبعادية عنفاً أكبر، حيث تتصارع النخب على من يملك زمام السلطة، ربما يفسر ذلك التاريخ الطويل لأميركا الجنوبية العامر بالانقلابات والحروب الأهلية.
لا يمكن للخبراء والمتخصصين أن يضعوا هياكل الرخاء عن طريق تقديم النصح للحكام بشأن الطريقة المثلى لصنع السياسات أو إدارة المؤسسات، فالحكام لن يتبعوا تلك النصائح ليس عن جهل أو خطأ ولكن عمداً، يتغير ذلك عندما يتشكل ائتلاف واسع قادر على فرض رؤيته على النخبة التي يجب أن تشمل تعددية سياسية تنافسية (مثال ذلك الثورة الإنجليزية، إطاحة الميجي بالنظام الإقطاعي في اليابان، تمكن بوتسوانا الديمقراطية من إخراج الاحتلال الإنجليزي).
بإمكان الدول الاستبعادية أن تحقق بعض النمو، فذلك النمو سيسمح للنخبة باقتطاع المزيد من الأموال لنفسها، لكن من المعروف أن النمو السلطوي غير قابل للاستمرار، يعي الاقتصاديون ذلك منذ جوزيف شامبيتر في الأربعينيات، فاستمرارية النمو تتطلب ما يعرف باسم “التحطيم المبدع”creative destructiontion ربما يبدو الاقتصاد الصيني جذاباً، لكن الصينين أنفسهم اكتشفوا ضعفاً خطيراً في هيكلهم الاقتصادي الذي على أثره ألقوا بـ”داي جو فانج” في السجن عام 2003
تتمثل جريمة داي فونج في كونه أسس شركة لإنتاج الصلب بتكلفة منخفضة، كان من المتوقع أن تنافس هذه الشركة مصانع الحزب الصيني الحاكم، لم يكن أعضاء النخبة الصينية أن يسمحوا لهذا النوع من التهديد أن يستمر، ومن ثم فإن النمو الصيني لا يعول على استمراريته، يمكن الإشارة أيضاً إلى الحالة السوفييتية، حيث شهدت نمواً متسارعاً في الخمسينيات والستينيات إلا أنها بعد ذلك وصلت لمرحلة اقتصاد غير قادر على الإبداع وسقط في الركود، ومن المتوقع أن يسلك الصينيون مسلك السوفييت نفسه بعد حين.
يخلص الكتاب في النهاية إلى ارتباط عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بوجود مؤسسات استيعابية وتعددية، في حين يعزو عدم قدرة بعض الدول على تحقيق عملية التنمية إلى وجود مؤسسات إقصائية تعمل لصالح نخبة تراكم الأموال التي بدورها تدعم المؤسسات الإقصائية.
تقييم الأفكار الواردة في الكتاب
من حيث المنهجية اعتمد الكتاب بشكل كبير على منهجي دراسة الحالة والمنهج التاريخي، من دون وجود عمل إحصائي رقمي قادر على الوصول إلى نتائج حاسمة، فالمنهج التاريخي غير قادر لوحده على إجابة الأسئلة الكبرى خاصة تلك المتعلقة بالليبرالية والديمقراطية ومصائر الأمم، إضافة إلى ذلك فقد تعمد الكاتب أن يذكر الأحداث التاريخية التي فقط تؤيد سرديته؛ من حيث كون المؤسسات هي السبب في وجود أمم فاشلة، فعلى سبيل المثال فهو يعزو فشل وسقوط مدينة “البندقية” في العصور الوسطى إلى المؤسسات من دون أن يذكر شيئاً عن دور تحول طرق التجارة من المتوسط إلى الأطلنطي الذي ساهم كثيراً في إضعاف النظام الحاكم فيها.
من حيث المضمون فقد حصر الكاتب “كوابح القوة السياسية” في الانتخابات الديمقراطية والدساتير المكتوبة، في حين إن شرط الكتابة في الدساتير يبدو غير منطقي، فالمملكة المتحدة ليس لديها دستور مكتوب لكن سيادة قيم احترام القانون كفيلة بلعب دور الكابح للقوة السياسية، أيضاً فإن الكاتب ربط بين التجربتين السوفييتية والصينية رغم الاختلافات بينهما، فالتجربة السوفييتية كانت انغلاقية بامتياز، ما عجل سقوطها، في حين تمارس الصين انفتاحاً محسوباً بما يحقق مصالحها ويدعم استمرارية عملية النمو بها، فالصين عضو بمنظمة التجارة العالمية منذ 2001، كما أن لها استثمارات ضخمة في شتى أنحاء العالم، على رأسها الاستثمارات في سندات الدين الأميركية، الأمر الذي يعني أن النظام الدولي لن يكون سعيداً باحتمالات السقوط الصيني وربما يمنعه خوفاً على مصالحه.
على الجانب الآخر جاء طرح الكاتب الخاص بمؤسسة العبودية ودورها في إفقار الأمم وتخلفها منطقياً ومدعوماً ببعض الأدلة التاريخية، إلا أنه كان ينقصه أمثلة صارخة وقاطعة لو ذُكرت لدعمت الفكرة بشكل كامل، مثال ذلك حالة الكونغو التي تسببت العبودية في إفقارها بشكل واضح، وحال الاستعمار الإسباني لبيرو، حيث ثبت إحصائياً أن المناطق التي عانت من الممارسات القمعية لمؤسسة العبودية الإسبانية أكثر فقراً بنسبة 25% من غيرها من المناطق المحيطة التي لم تتعرض لذلك.