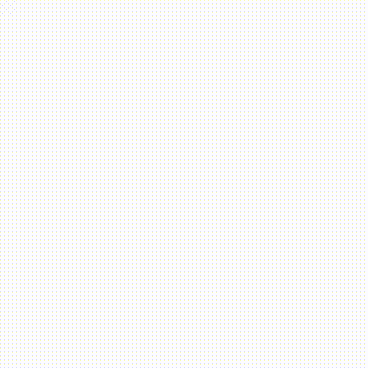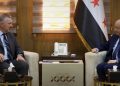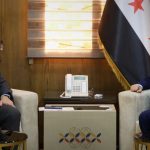ملخص
يمكن لحملات القصف والاحتلالات العسكرية وغيرها من صور الحروب الحديثة أن تدمر النظم البيئية، مما يؤدي إلى فقدان موائل طبيعية حيوية لأنواع لا حصر لها، إذ غالباً ما تتضمن الأنشطة العسكرية إزالة مساحات شاسعة من الأراضي لبناء القواعد وطرق النقل والمنشآت الدفاعية. وفي بعض الحالات تدمر النظم البيئية بأكملها لحرمان الأعداء من المأوى، مما يجبر السكان المحليين على الإخلاء وتترك مساحات شاسعة من الأراضي غير صالحة للحياة البرية.
“أنت وحدك من يستطيع منع غابة”، هذا كان شعار عملية “رانش هاند” التي أطلقتها الولايات المتحدة في حربها على غابات فيتنام المطيرة الكثيفة، إذ تعد التكتيكات الحربية التي استخدمتها الديمقراطية الأميركية ضد الطبيعة والبيئة في فيتنام فريدة من نوعها تاريخياً، فبين عامي 1965 و1973 استخدم ما يقارب 85 في المئة من الذخائر الأميركية في حرب فيتنام، ليس ضد جنود العدو، بل ضد المناظر الطبيعية والأراضي الزراعية ومصادر المياه وطرق النقل، وقد كان الضرر الناتج الذي لحق بالنظام البيئي الفيتنامي جسيماً لدرجة أن مصطلح “الإبادة البيئية” ظهر في الأوساط العلمية.

ثغرة كبيرة
كل هذه الأرقام والمعلومات جزء بسيط لآثار صراع عسكري واحد ما زالت فيتنام تدفع ثمنه إلى يومنا هذا، فكيف بباقي الصراعات العسكرية التي شهدتها هذه الأرض، وعاثت في برها وبحرها وجوهاً وكائناتها البرية من متناهية الصغر إلى أضخمها، إضافة لإنسانها، خراباً وتلويثاً لا يحتسب في قانون المحاسبة المناخية، إذ لا يطلب من البلدان الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية في إطار الاتفاقات المناخية الدولية، مما يعني أن مصدراً مهماً وكبيراً من غازات الدفيئة يبقى مخفياً.
فعندما اعتمد بروتوكول “كيوتو” عام 1997، استثنيت الانبعاثات العسكرية تحديداً من الالتزامات الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبالمثل، بموجب اتفاقية “باريس” لعام 2015، عوملت الانبعاثات العسكرية على أنها تقارير طوعية، مما سمح باستمرار التقليل من شأن الخسائر البيئية الحقيقية للحروب. ونتيجة لذلك، غالباً ما يقلل من شأن تأثير العمليات العسكرية العالمية على المناخ، على رغم أن المجمع الصناعي العسكري يعد اً رئيساً في ظاهرة الاحتباس الحراري. ويمثل هذا الاستثناء ثغرة كبيرة، ويحافظ عليه عمداً في الحوكمة المناخية العالمية لخدمة مصالح المجمع الصناعي العسكري والقوى العظمى.
وتسهم جيوش العالم مجتمعة بنحو 5.5 في المئة من إجمال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وهو ما يعادل انبعاثات دولة صناعية بأكملها، ولو كانت الجيوش العالمية دولة واحدة، لكانت رابع أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري، بعد الهند وروسيا مباشرة، إضافة لذلك، لو اعتبر الجيش الأميركي دولة واحدة، لكان في المرتبة الـ 47 عالمياً من حيث الانبعاثات، إذ ستتجاوز انبعاثاته الإجمالية انبعاثات دول مثل الدنمارك والسويد والبرتغال، إلا أن هذه النسبة المنبثقة من الجيوش لا تشمل سوى الانبعاثات الروتينية الناتجة من صيانة الجيش، ولا تشمل الانبعاثات الناتجة من إلقاء القنابل أو نشر القوات أو شن الحروب بأي صورة من الصور.
الضرر البيئي قبل النزاعات
يبدأ الأثر البيئي للحروب قبل اندلاعها بفترة طويلة، فبناء القوات العسكرية ودعمها يستهلك كميات هائلة من الموارد، كالمعادن الشائعة والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، إضافة إلى المياه والهيدروكربونات. ويعد التحكم في المعادن الحيوية ذات الأهمية العسكرية اعتباراً استراتيجياً متزايد الأهمية للجيوش، كما يتضح من السياسات المتبعة تجاه أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتطلب الحفاظ على الجاهزية العسكرية التدريب، والتدريب بدوره يستهلك موارد، فالمركبات العسكرية والطائرات والسفن والمباني والبنية التحتية جميعها تحتاج إلى طاقة، وغالباً ما تكون هذه الطاقة نفطية، وتكون كفاءة استخدامها منخفضة.
وتحتاج الجيوش إلى مساحات شاسعة من اليابسة والبحر، سواء لإقامة القواعد والمنشآت، أو لإجراء الاختبارات والتدريبات، ويعتقد أن الأراضي العسكرية تغطي ما بين واحد وستة في المئة من مساحة اليابسة العالمية. وفي كثير من الحالات، تعد هذه المناطق ذات أهمية بيئية بالغة، إذ يؤدي التدريب العسكري إلى انبعاثات، واضطرابات في المناظر الطبيعية والموائل البرية والبحرية، فضلاً عن التلوث الكيماوي والضوضائي الناتج من استخدام الأسلحة والطائرات والمركبات، إضافة إلى إن صيانة وتجديد المعدات والعتاد العسكري يستلزم كلف مستمرة للتخلص منها ما يؤثر في البيئة، ولا تقتصر المشكلات البيئية طوال دورة حياة الأسلحة النووية والكيماوية الأكثر خطورة على ذلك فحسب، بل تشمل أيضاً الأسلحة التقليدية، لا سيما عند التخلص منها من طريق الحرق المكشوف أو التفجير، فتاريخياً ألقيت كميات هائلة من الذخائر الفائضة في البحر.

جنون التلويث خلال الحرب
خلال الحروب، تطلق الذخائر المتفجرة كالقنابل والصواريخ وقذائف المدفعية في البيئة، وينتج كل انفجار انبعاثات. وقد أطلق الجيش الأميركي وحده أكثر من 337 ألف قنبلة وصاروخ خلال العقدين الماضيين، حيث يسهم كل منها في تلوث الغلاف الجوي، وتستهلك القاذفات والطائرات المقاتلة التي تنقل هذه الأسلحة كميات هائلة من الوقود، ويسهم كل انفجار في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتسرع الحروب من الأثر البيئي من خلال استهدافها المباشر للبنية التحتية لإنتاج النفط وتخزينه ونقله، وقد شهدت دول مثل كولومبيا وليبيا وسوريا والعراق استهداف بنيتها التحتية النفطية في نزاعات عسكرية، مما أدى إلى عواقب بيئية وخيمة.
وأدت الحرب على الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة، والتي امتدت عبر دول، من بينها أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، إلى انبعاث ما يقدر بنحو 1.2 مليار طن متري من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وهذا يعادل تقريباً الانبعاثات الناتجة من 257 مليون سيارة سنوياً. وتسهم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، حتى من دون احتساب فترات النزاع النشط، بنحو سبعة ملايين طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل انبعاثات قبرص. وعند إضافة العمليات العسكرية، ترتفع هذه الأرقام بصورة كبيرة، إذ يعد استخدام الجيش الأميركي المكثف رحلات الشحن الجوي لنقل المعدات ذا بصمة كربونية كبيرة، فقد أسفرت 200 رحلة شحن جوي عن استهلاك 50 مليون ليتر من وقود الطائرات، ونقل أكثر من 10 آلاف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، عن 133 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذا يفوق إجمال انبعاثات غرينادا طوال عام، مما يبرز الطبيعة كثيفة الكربون للخدمات اللوجيستية العسكرية. وفي عام 2022 أنتج الجيش الأميركي وحده نحو 48 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر من إجمال الانبعاثات السنوية لـ150 دولة منفردة، بما في ذلك دول مثل النرويج وإيرلندا وأذربيجان.

بضعة أمثلة
وكمثالين حاليين، الأول عن غزة، فقد كشف تقرير حديث عن أن الانبعاثات الفورية للهجمات الجوية والبرية خلال أول 120 يوماً من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني كانت أكبر من الانبعاثات السنوية لـ26 دولة وإقليماً. وعندما أضاف الباحثون الانبعاثات الوسيطة، كالبنية التحتية الحربية التي بنتها إسرائيل و”حماس”، بما في ذلك شبكة الأنفاق الضخمة التابعة للحركة، فقد ارتفع إجمال الانبعاثات إلى ما يزيد على انبعاثات 36 دولة وإقليماً، وعليه ستكون الكلف المناخية طويلة الأجل لإعادة إعمار غزة أكبر بكثير من كلف القصف والعمليات البرية.
أما المثال الثاني فهو أوكرانيا، فقد كشفت دراسة بحثية أخرى عن نتائج مماثلة، إذ وجد الباحثون أن انبعاثات الكربون الناتجة من 12 شهراً من الحرب بين روسيا وأوكرانيا تعادل تقريباً الانبعاثات السنوية لبلجيكا، أي ما يعادل 120 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون. ويشمل هذا الحساب الانبعاثات الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل، ويشير التقرير إلى أن إعادة بناء البنية التحتية المدنية تمثل الحصة الكبرى من الانبعاثات، إذ تصل إلى ما يقارب نصف إجمال الانبعاثات.
أما في التاريخ الحديث، فخلال حرب يوليو (تموز) التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006، أدى قصف محطة “الجية” (جبل لبنان) لتوليد الطاقة في لبنان إلى تسرب ما يقدر بنحو 10000 إلى 15000 طن من النفط إلى البحر الأبيض المتوسط، وقد تسبب التسرب النفطي على السواحل اللبنانية وامتد إلى المياه السورية، في أضرار بيئية جسيمة، حيث نفقت الكائنات البحرية، بما في ذلك الطيور البحرية والأسماك، ودمرت صناعات الصيد المحلية. أما خلال حرب الخليج عام 1991، فقد استخدم ما يقدر بنحو 320 طناً من ذخائر اليورانيوم المنضب السمي ذي الآثار البيئية طويلة الأمد على كل كائن حي لأجيال.
انبعاثات وقت السلم
يمتلك الجيش الأميركي 742 قاعدة عسكرية موزعة على 82 دولة وإقليماً، مع 171736 فرداً منتشرين في 177 دولة، إضافة إلى 1.2 مليون جندي متمركزين في الولايات المتحدة، وتستهلك كل قاعدة من هذه القواعد كميات كبيرة من الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقوداً للمركبات والطائرات أو وقوداً أحفورياً يستخدم في العمليات العسكرية. وفي دول مثل بريطانيا، حيث يمتلك الجيش 145 موقعاً خارجياً في 42 دولة، تسهم الانبعاثات الصادرة من هذه القواعد في البصمة البيئية الإجمالية للجيش. وتمتلك روسيا والهند 21 وثلاث قواعد عسكرية خارجية على التوالي، وتعد وزارة الدفاع البريطانية وحدها من أكبر مستهلكي الوقود الأحفوري داخل الحكومة، وتلاحظ أنماط مماثلة في جيوش أخرى، بما في ذلك روسيا والسعودية وإسرائيل والصين.
وتخلف الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة خلال النزاعات آثاراً بيئية وخيمة، فالألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة قد تعوق الوصول إلى الأراضي الزراعية وتلوث التربة ومصادر المياه بالمعادن والمواد النشطة السامة. وفي النزاعات الكبرى، قد تنتج أو تهمل كميات هائلة من الخردة العسكرية، والتي قد تحوي مجموعة متنوعة من المواد الملوثة، ملوثة التربة والمياه الجوفية، ومعرضة العاملين فيها لأخطار صحية حادة ومزمنة، وتسبب السفن والغواصات والبنية التحتية النفطية البحرية المحطمة أو المتضررة تلوثاً بحرياً.
تدمير النظم البيئية
لذا، يمكن لحملات القصف والاحتلالات العسكرية وغيرها من صور الحروب الحديثة أن تدمر النظم البيئية، مما يؤدي إلى فقدان موائل طبيعية حيوية لأنواع لا حصر لها، إذ غالباً ما تتضمن الأنشطة العسكرية إزالة مساحات شاسعة من الأراضي لبناء القواعد وطرق النقل والمنشآت الدفاعية. وفي بعض الحالات، تدمر النظم البيئية بأكملها لحرمان الأعداء من المأوى، مما يجبر السكان المحليين على الإخلاء وتترك مساحات شاسعة من الأراضي غير صالحة للحياة البرية، إذ يمتد الأثر البيئي لهذه الأعمال إلى ما هو أبعد من منطقة الحرب، إذ إن هذه النظم البيئية غالباً ما تكون غير قابلة للتعويض، وقد تستغرق أجيالاً للتعافي، إن تعافت أصلاً.
وتشير الدراسات إلى أن أعداد الحيوانات الكبيرة في منطقة ما قد تنخفض بنسبة تصل إلى 90 في المئة خلال الحروب، بل إن عاماً واحداً من الصراع قد يؤدي إلى خسائر طويلة الأمد في الحياة البرية. ففي تسعينيات القرن الماضي أدى التجفيف والتدمير المتعمد لأهوار بلاد ما بين النهرين في العراق إلى فقدان 90 في المئة من هذا النظام البيئي الحيوي، مما تسبب في نزوح سكان الأهوار الذين كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم.
ولليوم، ما زال تأثير “الديوكسين” الذي رُشَّ في إطار العامل البرتقالي على تسميم الحيوانات في حرب فيتنام يظهر على معدلات الإجهاض والإعاقات في عالم الحيوان، وثمة أدلة كثيرة تشير إلى أن حيوانات المزارع، مثل الأبقار والخنازير والأيائل الحمراء، تعاني ارتفاع معدلات الوفيات والأمراض نتيجة تناولها أعشاباً ملوثة بـ”الديوكسين”، فكيف بالإنسان؟!
المصدر: إندبندنت عربية