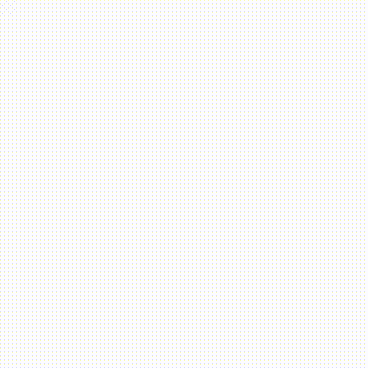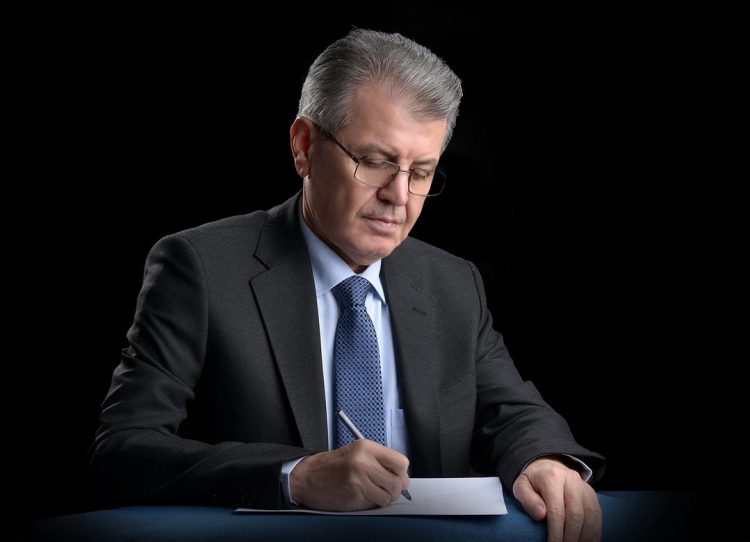يقدّم هذا الحوار قراءةً فكريةً وتحليليةً للدكتور الصيدلاني طارق عفّاش، العالم والمخترع والباحث في الصناعات الصيدلانية والكيميائية، وأحد روّاد توطين التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد المعرفي في سوريا والعالم العربي.
تجمع مسيرته بين: البحث العلمي، العمل الصناعي، والتحليل الجيوسياسي والاقتصادي، ويشغل مناصب فكرية وعلمية دولية عدّة، من بينها: رئاسة اتحاد البرلمانيين الدولي لحماية البيئة، ورئاسة تحرير موسوعة :”المستقبل العربي للإبداع والاختراع” ومجلة “العالم الاقتصادي”، كما أسّس مشروع “وادي السيليكون السوري”، ومشروع “البوابة الفينيقية” كمجمّع سكني ذكي مستدام في منطقة المزة بدمشق، إضافة إلى تأسيس “مجموعة الطارق للصناعات الصيدلانية والكيميائية”.
لا ينطلق هذا الحوار من إطار نظري أكاديمي صرف، بل من تجربة علمية ومهنية وإنسانية مركّبة؛ تبلورت عبر: العمل البحثي في أوروبا، محاولات المساهمة في بناء اقتصاد معرفي منتج في سوريا، وما استتبعها من صدام مباشر مع بنية النظام المخلوع؛ انتهى بالاعتقال وتعطيل المشاريع.
وقد شكّلت تجربة مرض السرطان محطةً إنسانيةً كاشفةً لحدود المعرفة النظرية، وأسهمت في تعميق الإحساس بالمسؤولية العامة. ومن هذا المنطلق، يتجاوز الحوار توصيف التحولات الدولية والمسألة السورية، ليقدم مقاربة مركّبة؛ تربط الجغرافيا السياسية بالاقتصاد؛ وتضع الإنسان ورأس المال البشري في قلب أي مشروع نهوض وتنمية مستدامة.
* كيف تقيّمون التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي اليوم؟
ما نشهده اليوم لا يقتصر على التبدّل في موازين القوى بين دول صاعدة وأخرى متراجعة، بل يمثل إعادة تشكل بنيوية لمفهوم القوة ذاته، فإذا كان القرن العشرون قرن الجغرافيا العسكرية والصراعات الحدودية، فإن العقود الأخيرة شهدت انتقال مركز الثقل نحو القدرة على: إنتاج المعرفة، التحكم بالتكنولوجيا المتقدمة، وإدارة البنى الرقمية والمالية والإعلامية العابرة للحدود.
لم يعد ممكناً فهم النظام الدولي من زاوية جيوسياسية تقليدية فقط، بل من خلال مقاربة مركّبة؛ تجمع بين ثلاثة أبعاد متداخلة: البعد الجيوسياسي المرتبط بالموقع والتحالفات، والبعد الاقتصادي – الهيكلي المتصل بسلاسل القيمة والتصنيع والتمويل، والبعد الإنساني – المعرفي المرتبط برأس المال البشري، وأنماط الحكم، وتجربة الأفراد داخل دولهم.
هذه المقاربة تتيح فهماً أعمق لكيفية انعكاس اختلال النظام الدولي على حياة الناس ومسارات الدول النامية، ومنها سوريا.
* ما مكونات القوة في النظام الدولي الجديد، من وجهة نظركم؟
القوة اليوم لم تعد تُقاس بعدد الجيوش أو حجم الترسانة فقط، بل بمدى القدرة على التأثير في قرارات الآخرين والتحكّم بمستقبلهم الاقتصادي والتقني والسياسي، ويمكن تلخيص هذه القوة في ستة مكوّنات رئيسة:
أولاً: التكنولوجيا المتقدمة
فالذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، والفضاء، والبنية الرقمية أصبحت ركائز الاقتصاد والأمن والإعلام، من يمتلك هذه التكنولوجيا يمتلك القدرة على: التطوير أو المنع أو الإقصاء من دون اللجوء إلى الحرب.
ثانياً: الطاقة والموارد
لم يعد النفط والغاز وحدهما مصدر القوة، بل السيطرة على مصادر الطاقة المتجددة والمعادن النادرة اللازمة لها، من يتحكم بالطاقة يتحكم بتكلفة الإنتاج والاستقرار والتنمية.
ثالثاً: المال والنظام المالي
العملات، البنوك، أنظمة الدفع، والعقوبات الاقتصادية باتت أدوات ضغط فعالة قد تشل دولاً كاملة من دون رصاصة واحدة.
رابعاً: سلاسل التوريد والتجارة
السيطرة على الموانئ والممرات البحرية والغذاء والدواء تمثل قوة صامتة لكنها حاسمة في حماية الاستقرار أو تهديده.
خامساً: الإنسان والمؤسسات
التعليم، البحث العلمي، والمؤسسات القادرة على الابتكار هي ما يجعل القوة مستدامة، من يخسر كفاءاته يخسر مستقبله.
سادساً: الإعلام والسرديات والفاعلون غير الدوليين.
من يمتلك المنصات ويصوغ الرواية يؤثر في الرأي العام والشرعية، وأصبحت الشركات الكبرى والمنصات الرقمية ومنظمات المجتمع المدني لاعبين يوازون الدول في التأثير.
* أين تقف الولايات المتحدة في هذا التحول العالمي، هل تتراجع أم تعيد ترتيب ملفاتها؟
ما يجري في الولايات المتحدة أقرب إلى تكيف استراتيجي منه تراجعاً حتمياً، صحيح أن واشنطن تبدو أقل اندفاعاً في لعب دور «شرطي العالم»، لكنها في المقابل تعيد ترتيب أولوياتها لحماية تفوقها في مجالات حاسمة، فهي تركز على: حماية صناعاتها التكنولوجية الحيوية، إعادة ضبط سلاسل التوريد الحساسة، ولا سيما في مجالات الرقائق الدقيقة والذكاء الاصطناعي، كما تعزّز موقعها لاعباً مركزياً في أسواق الطاقة التقليدية والمتجددة، وتوظف قوتها الناعمة وقدرتها التنظيمية لصياغة المعايير الناظمة للتكنولوجيا والاقتصاد العالمي. بهذا المعنى، تتحول الولايات المتحدة من قوة انتشار عسكري مباشر إلى قوة أكثر براغماتية، لكنها تبقى لاعباً حاسماً في رسم قواعد النظام الدولي.
* وماذا عن الصين، ما الذي يميز صعودها الحالي؟
تمثل الصين نموذج صعود استراتيجي طويل الأمد؛ يقوم على إعادة تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي أكثر مما يقوم على الصدام المباشر مع الولايات المتحدة.
رهانها الأساسي هو الاقتصاد والمعرفة لا القوة العسكرية، فهي تبني قدراتها الصناعية والتكنولوجية الذاتية، وتوسّع نفوذها عبر الاقتصاد من خلال نسخة أكثر انتقائية من مبادرة «الحزام والطريق»، مع الحفاظ على فائض تجاري كبير بالرغم من الضغوط، وفي الوقت نفسه، تواجه تحديات داخلية تتعلق بتباطؤ النمو وأزمة القطاع العقاري.
* كيف تنظرون إلى وضع أوروبا وبقية القوى الصاعدة في النظام الدولي الجديد؟
تمثل أوروبا قوةً اقتصاديةً وتنظيميةً ومعرفية كبرى، لكن: الشيخوخة السكانية، ارتفاع مستويات الدين العام في عدد من دولها، إضافة إلى تباين الأولويات الوطنية، تحدّ من قدرتها على لعب دور استراتيجي موحّد ومستدام.
بينما تواصل اليابان ترسيخ مكانتها كقوة علمية وتقنية متقدمة، مستندة إلى قاعدة صناعية ومعرفية متينة، إلا أن الشيخوخة السكانية الحادة وتراكم الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي؛ تُقلّص هامش دورها القيادي المستقل، مع احتفاظها بدور مؤثر ضمن شبكة تحالفات استراتيجية.
أما روسيا فتعتمد في موقعها الدولي على ثقلها العسكري ومواردها الطبيعية، غير أن محدودية التنويع الاقتصادي والقيود البنيوية تقلّصان قدرتها على إنتاج نفوذ شامل ومستدام.
وتبرز الهند كقوة صاعدة تمتلك ثقلاً ديموغرافياً واقتصاداً متنامياً، لكن: تحديات التنمية، والبنية التحتية، وعدم تكافؤ النمو، تجعل صعودها تدريجياً ومشروطاً بقدرتها على تحويل هذا الثقل إلى قوة معرفية وتقنية.
بصورة عامة، لا يسير النظام الدولي باتجاه تعددية أقطاب متكافئة، بقدر ما يتشكل حول تعدد مراكز تأثير متفاوتة القوة، لكل منها أدواتها الخاصة وحدود قدرتها على التأثير.
* بالانتقال إلى العالم العربي.. ما نقاط القوة والتحديات الأساسية في رأيكم؟
يمتلك العالم العربي عناصر قوة حقيقية، في مقدمتها: موقع جغرافي استراتيجي؛ يربط ثلاث قارات، موارد طاقة كبيرة، كتلة سكانية شابة، وأسواق واسعة، غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في نقص هذه الإمكانات، بل في ضعف القدرة على توظيفها، فـ: غياب الحوكمة الرشيدة، ضعف المؤسسات، والاعتماد المزمن على الاقتصاد الريعي، تحدّ من تحويل الموارد إلى إنتاج مستدام وتنمية شاملة.
التحديات الجوهرية هي: بناء دول قادرة على التخطيط طويل الأمد، الاستثمار في الإنسان؛ عبر التعليم والبحث العلمي، وخلق بيئة تشجّع الابتكار والإنتاج.
من دون ذلك، تبقى الاقتصادات العربية هشّةً ومعرضةً للتقلبات مهما امتلكت من ثروات.
في هذا السياق، تمثل دول الخليج مساراً انتقالياً مهماً، إذ بدأت تدرك حدود النمو القائم على النفط، وتتجه نحو تنويع اقتصاداتها، وتُعدّ رؤية السعودية (2030) مثالاً واضحاً على هذا التحول، كما تقدم الإمارات نموذجاً لاقتصاد منفتح قائم على: المعرفة، وجذب الاستثمارات والكفاءات، أما الدول العربية الخارجة من النزاعات، فمستقبلها التنموي يبقى مرتبطاً أولاً بالاستقرار السياسي وبناء مؤسسات فعالة.
* دعونا ندخل إلى الملف السوري.. كيف تصفون جذور الأزمة الاقتصادية قبل عام 2011؟
لم تكن الأزمة الاقتصادية في سوريا قبل عام 2011 وليدة ظرف طارئ، بل نتيجة تراكم طويل من السياسات المختلة وتراجع وظائف الدولة الأساسية، فقد انحسر الدور التنموي والتخطيطي والرقابي للدولة، مقابل تصاعد الدور الأمني، ما أضعف إدارة الاقتصاد وحوّل السوق إلى مجال تحكمه الاعتبارات السياسية لا التنموية.
في هذا السياق، لعب الفساد البنيوي واحتكار قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، من قبل شبكات مرتبطة بالسلطة، دوراً محورياً في: إضعاف المنافسة، وإقصاء الفاعلين المستقلين، ما أسهم في تآكل القطاعات الإنتاجية، ولاسيما الصناعة والزراعة، ومع غياب الشفافية والمساءلة؛ ترسّخ اقتصاد المحسوبية، فتآكلت الطبقة الوسطى وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، في ظل غياب سياسات اجتماعية فعّالة، ومع انسداد المجال العام وتصاعد القبضة الأمنية، تشكّلت بيئة انفجارية قادت إلى اندلاع الثورة، قبل أن تنتقل البلاد إلى مسار تدمير شامل للبنية الإنتاجية والمؤسسية.
* ما الذي تغيّر في الاقتصاد السوري بعد التحرير عام 2024، وما العناصر الصالحة للبناء عليها؟
يمكن اعتبار التحرير عام 2024 نقطة تحول أساسية؛ أعادت توجيه الاقتصاد السوري من منطق الريع والمحسوبية نحو مسار أكثر توازناً؛ يقوم على: استعادة القرار المؤسسي، وتعزيز دور الدولة كمنظّم للتنمية ضمن اقتصاد سوق منضبط، ويعكس هذا التحول ملامح انتقال تدريجي نحو نموذج الدولة التنموية، حيث تُضبط آليات السوق بإطار قانوني واضح، وتُربط الامتيازات بالكفاءة والمساءلة، ما أسهم في استعادة حدٍّ أولي من الثقة الاقتصادية، وهي شرط جوهري لأي تعافٍ مستدام.
وبالرغم من حجم الدمار، لا يزال الاقتصاد السوري يمتلك مقومات حقيقية للنهوض، أبرزها: قطاع زراعي قادر على دعم الأمن الغذائي، قطاع دوائي يمتلك خبرة إنتاجية وتصديرية، إضافة إلى صناعات صغيرة ومتوسطة متجذّرة اجتماعياً وقابلة للتحول إلى قاعدة إنتاجية مرنة؛ إذا ما أُدرجت ضمن سياسات صناعية واضحة وشراكة فعّالة بين الدولة والقطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق، تُفهم إعادة الإعمار لا بوصفها مجرد معالجة للأضرار المادية، بل كمسار لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية على أسس إنتاجية ومعرفية؛ تقوم على: الاستثمار في رأس المال البشري، تطوير القدرات التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، كما يتيح ذلك تحويل الموقع الجغرافي لسوريا إلى ميزة استراتيجية فاعلة ضمن رؤية إقليمية واضحة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر توازناً وقدرة على الاستدامة.
* قبل أن ندخل في مسيرتكم المهنية والفكرية، نود التوقف عند البدايات. كيف أسهمت تجربتكم الشخصية، منذ الطفولة وحتى الدراسة والاغتراب، في تشكيل وعيكم ومساركم؟
وُلدتُ عام 1961 في قرية قرحتا بمحافظة القنيطرة، في جغرافيا جمعت بين جمال المكان ومرارة الفقد. ترك النزوح أثره العميق في عائلتي، وحمل والداي رحمهما الله هذا الوجع طيلة حياتهما.
وفي المقابل، أسهمت هذه التجربة في بناء وعيٍ مبكر بقيمة الوطن، حيث غدا الانتماء فعلَ مسؤولية قبل أي شيء آخر.
اخترتُ دراسة الصيدلة في جامعة دمشق، حيث تشكّلت بدايات علاقتي بالعلم كأداة للفهم والتغيير. ثم قادتني الدراسة والعمل إلى فرنسا، حيث تعمّقت في التخصص واكتسبت خبرات بحثية ومهنية أوسع، ما عزّز قناعتي بأن المعرفة والعمل الجاد يمثلان وسيلة أساسية للمساهمة في تنمية الوطن.
* بالعودة إلى تجربتكم الشخصية، كيف انعكست محاولاتكم لبناء مشاريع تنموية مستقلة على رؤيتكم للاقتصاد والسياسة في السياق السوري؟
في عام 2002، ومع تصاعد خطاب النظام المخلوع بشأن الإصلاح والانفتاح، عدتُ إلى سوريا مدفوعاً بقناعة بإمكانية الإسهام في بناء مسار تنموي مختلف، أطلقت مجموعة مبادرات، في مقدمتها مشروع «وادي السيليكون السوري» للصناعات التكنولوجية، ومشروع «البوابة الفينيقية» كمجمّع سكني ذكي في دمشق، إلى جانب تأسيس «مجموعة الطارق للصناعات الصيدلانية والكيميائية» لبناء قطاع صناعي قادر على المنافسة والتصدير، وبالتوازي، جاءت مجلة «العالم الاقتصادي»؛ انطلاقاً من إيماني بأن التنمية لا تنفصل عن الفكر، وأن أي مشروع اقتصادي يحتاج إلى بيئة معرفية قائمة على التحليل العلمي.
غير أن هذه المبادرات اصطدمت بواقع سياسي – اقتصادي مغلق، تعامل معها النظام المخلوع؛ بوصفها مجالات لا يُسمح بالعمل فيها خارج منظومة النفوذ.
فُرضت عراقيل إدارية وأمنية متعمّدة، مع محاولات لفرض شراكات غير متكافئة؛ تُفرغ المشاريع من استقلالها، ومع رفضي ذلك، لجأ النظام إلى الاعتقال والملاحقة الأمنية، لذلك لا يمكن فهم تعطيل هذه المشاريع كخلل إداري فحسب، بل كسياسة سلطوية ترى في أي فاعل اقتصادي مستقل مدخلاً لاستقلال اجتماعي ومعرفي قد يتطور سياسياً.
وعلى الرغم من ذلك، أُسست «مجموعة الطارق» بعد جهود كبيرة، قبل أن تتعرض للتدمير خلال الرد المسلح للنظام المخلوع على الثورة؛ ضمن استهداف أوسع للمؤسسات الإنتاجية المستقلة.
* مررتم بتجربتين وجوديتين قاسيتين: المرض ثم الاعتقال، كيف تقرؤهما اليوم؟
حين يواجه الإنسان مرضاً، بحجم السرطان، لا يكون الصراع مع الجسد وحده، بل مع الزمن وفقدان السيطرة.
يتحول المستقبل إلى سؤال مفتوح، وتغدو الأيام انتظاراً مثقلاً بالقلق، هذه التجربة لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك العائلة الخوف والصمت، وتُختبر العلاقات الإنسانية بعمق، وبالرغم من القسوة، يتعلم الإنسان التمييز بين ما هو جوهري وما كان عبئاً.
المرض معلم قاسٍ، لكنه صادق.
أما الاعتقال، فهو تجربة مختلفة، الاعتقال لا يقيّد الجسد فقط، بل يستهدف الوعي عبر إنهاك الإرادة وتحويل الخوف إلى أداة ضبط. لذلك يصبح الحفاظ على التفكير المستقل شكلاً أساسياً من أشكال المقاومة.
وفي هذا السياق، يُفهم العنف في الأنظمة الاستبدادية كآلية بنيوية لإعادة إنتاج الطاعة، لا كاستثناء عابر.
غيّرت هاتان التجربتان نظرتي للحياة ولما أقوم به؛ فالمرض أعاد ترتيب الأولويات والمعنى، بينما كشف الاعتقال أن الوعي هو المساحة الأخيرة التي لا تستطيع القوة مصادرتها.
وبالرغم من اختلافهما، فقد قادتا إلى سؤال واحد: ماذا يبقى من الإنسان حين يفقد السيطرة؟ لا يكون الامتحان حينها في تغيير الواقع، بل في الحفاظ على صلة داخلية بالذات، ذلك الحضور الهادئ الذي يمنع الظرف من اختزال الإنسان، ويحول الوجود إلى مسؤولية إنسانية؛ تُقاس بما يتركه المرء من معنى وخير في حياة الآخرين.
* ما الرسالة التي تودون تركها في ختام هذا الحوار؟
إن الدول لا تنهض بالخطاب، بل بالقدرة على إدارة التنمية عبر مؤسسات عادلة وكفوءة؛ تحمي الإنسان وتربط السلطة بالمسؤولية، فالتنمية مسار طويل يتطلب رؤيةً واضحةً، وسياسات فعّالةً، وتوازناً مدروساً بين دور الدولة وآليات السوق.
وتمتلك سوريا مقومات حقيقية للنهوض، من: موقع، موارد، خبرات، رأسمال بشري، وتاريخ حضاري، غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل إدارة فعّالة، وحوكمة شفافة، واقتصاداً منتجاً قائماً على المعرفة، إلى جانب علاقة واضحة بين الدولة والقطاع الخاص؛ تقوم على الشراكة والمساءلة.
لقد فتح التحرير أفقاً جديداً، لكنه في جوهره شكّل بداية اختبار طويل. فالمرحلة المقبلة تقيس قدرة الدولة على الانتقال؛ من إدارة السيطرة إلى بناء المؤسسات؛ ومن الاستجابة للأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وفي هذا السياق، يقدّم نموذج الدولة التنموية مرجعاً عملياً لإعادة توجيه مسار التنمية، بشرط مواءمته مع الواقع الوطني وتحويله إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ويبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بالتزام سياسي واضح ومستدام بتنفيذ الإصلاحات، إلى جانب إصلاحات هيكلية متدرجة ومشاركة مجتمعية واعية تضمن المتابعة والمساءلة.
وإن الخطوات المتّخذة – حتى الآن- تعكس تحولاً في مقاربة التحديات، وتوفّر مؤشرات مهمّة يمكن البناء عليها، إذا ما جرى ترسيخها واستكمالها.