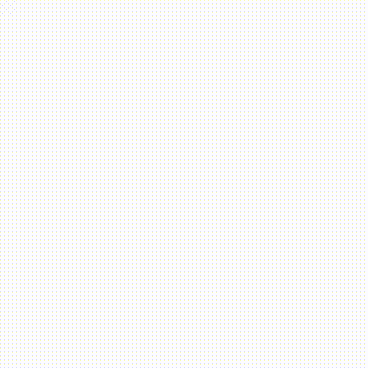بعد الثامن من كانون الأول 2024 تغيّر السياق السياسي في سوريا، وشرعت بوادر الانفتاح الخارجي أبواباً أمام تدفّق استثماراتٍ واتفاقياتٍ كبرى، لكن أثر ذلك على التشغيل لا يزال متدرجاً ومشحونًا بتناقضاتٍ بنيوية. فـهل يمكن أن تتحول عقود الطاقة والمشروعات الممتدة إلى عشرات الآلاف من الوظائف؟ أم أن سوق العمل، لا سيما بين المتعلمين، سيبقى أسير فجوة مهارية وبنيوية؟
المشهد الكلي والأرقام الأساسية
تُقاس مؤشرات التشغيل في سوريا بعد سنوات من الاضطراب بفجوة واضحة بين العرض والطلب على العمل، إذ تشير بيانات منظمة العمل الدولية ومنصّات إحصائية دولية إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة بقي منخفضاً، بنحو 37.9% خلال 2024، مع تباين كبير بين مشاركة الرجال والنساء. فيما تُظهِر تقديرات الأمم والمؤسسات الدولية أن معدلات البطالة تبقى مرتفعة مع إصدارات مختلفة للقياسات؛ البنك الدولي بدوره يشير إلى أن نموذجَات تقديرية تضع نسبة البطالة عند مستويات قريبة من 13% في 2024، بينما تسجل بعض مصادر العمل الدولية أرقامًا أعلى عند قياسات بديلة للبطالة والبطالة الشابة. هذه الأرقام تعبّر عن تراكم بطالة على مدار سنوات الانكماش، وترسم خط الانطلاق الذي ستتعاطى معه الاستثمارات القادمة.
الاستثمار على الطاولة… لكن التشغيل يحتاج وقتًا
خلال الأشهر اللاحقة لسقوط نظام الأسد ومباشرة الحكومة الانتقالية عملها، شهدت سوريا تدرّجاً في إعادة إدماجها بالاقتصاد الدولي: قرارات رفع قيود وعقود للطاقة، واستئناف تصدير النفط بطريقة رسمية، بالإضافة إلى زيارات فنية من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. هذه الوقائع فتحت منافذ استثمارية وعقوداً للبنى التحتية والطاقة، لكنها لم تُترجم فوراً إلى تشغيل واسع النطاق، لأن غالبية الاتفاقيات تحتاج إلى زمن تنفيذ طويل واستثمارات رأسمالية ضخمة قبل أن تتحول إلى مشاريع توظيفية مباشرة.
وهذا ما دفع عدداً من الخبراء إلى التحذير من أن “الإيرادات الاستثمارية” تبقى “سياسية” أكثر من كونها “واقعية” أيّ أنها تخلق أجواء تفاؤل، لكنها لا تُترجم إلى وظائف مستقرة على الأرض بسرعة.
تحديات سوق العمل بعد سقوط النظام البائد
في حديثه مع “المدن” يؤكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن الاقتصاد السوري يمر بعد سقوط النظام بمرحلة انتقالية معقدة، تتميز بخلخلة البنى التقليدية وظهور فرص جديدة لإعادة البناء. ويشير إلى أن الاقتصاد الكلي يعاني من فجوة كبيرة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي، بينما تفتح الاستثمارات الخارجية وإعادة إدماج سوريا في الأسواق الإقليمية والدولية نافذة أمل لإعادة التوازن.
ويضيف قوشجي أن الأرقام الرسمية حول البطالة غير موثوق فيها ، ولا يمكن القول حتى الآن بأن سوق العمل بدأت تتعافى أو أن البطالة تتناقص، ما لم تدخل استثمارات جديدة تؤثر فعلياً على النشاط الاقتصادي، إذ أن بدء هذه الاستثمارات سيزيد الطلب على العمالة. ويشير إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية لا تلعب أي دور محوري في تحديد اتجاهات البطالة، “فالموازنة العامة للعام 2026 لم تُعرض بعد، ولا يزال النظام الضريبي القديم سارياً، ولم يتم تفعيل أي خطط استثمارية واضحة. أما مصرف سوريا المركزي، فحتى الآن لم ينجح في ضبط سعر الصرف أو توفير السيولة عبر البنوك، ولا يزال سعر الفائدة المرتفع والرسوم على السحب قائمة، ما يعكس غياب دور رقابي حقيقي”.
وبالنسبة لتوقعات سوق العمل خلال 2026، يرى قوشجي أن الانفتاح الاقتصادي قد يؤدي إلى نمو نسبي في قطاعات البناء والطاقة والخدمات الرقمية مع دخول استثمارات عربية ودولية، وأن انخفاض البطالة ممكن إذا ترافقت الإصلاحات الاقتصادية مع تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وبرامج التدريب المهني التي تستهدف الشباب والخريجين. ويؤكد أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان نمو شامل ومستدام، لا يقتصر على قطاعات محدودة أو وظائف منخفضة الإنتاجية، بل يفتح المجال لفرص عمل نوعية تعزز الاستقرار الاجتماعي.
ويختتم قوشجي حديثه بالقول إن “سوريا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصادها على أسس حديثة، إلا أن نجاح المرحلة يعتمد على قدرة السياسات المالية والنقدية على خلق بيئة عمل مستقرة واستثمار رأس المال البشري بشكل فعّال”، مؤكداً أن العام المقبل قد يكون بداية لانخفاض ملموس في البطالة، خصوصاً بين الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، ما سيعزز الثقة الشعبية في مسار الإصلاح والانفتاح الاقتصادي.
البطء في الطلب وفرص القطاعات الواعدة
من جانبه، يشير خبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية ماهر رزق لـِ “المدن” إلى أن سوق العمل السورية لا تزال تزدحم بالتناقضات، مع وجود طلب متزايد على العمالة بشكل بطيء، وارتفاع تدريجي في متوسط الأجور، خصوصاً في القطاع الخاص. ويضيف أن الرواتب في الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات وخبرات تتراوح حالياً بين 200 و250 دولاراً، وترتفع تدريجياً كلما زادت المؤهلات والخبرات المطلوبة.
ويرى رزق أن الاستثمارات الخارجية، رغم محدوديتها، تحمل بعداً سياسياً أكثر منها واقعية عملية، وهو ما يوفر فرصة للتفكير في إعادة تأهيل الموارد البشرية وفق متطلبات المرحلة المقبلة، بعد سنوات العزلة التي أدت إلى تراجع الخبرات وهجرة الكفاءات في مختلف القطاعات.
وبخصوص القطاعات الواعدة، يؤكد أن الزراعة والصناعات المرتبطة بها ستبقى الأكثر قدرة على الصمود والنمو، تليها السياحة مع عودة سوريا إلى محيطها العربي، بينما يحتل قطاع الدراما المرتبة الثالثة من حيث الإمكانيات الاستثمارية، باعتباره أقل تأثراً بالعقوبات المفروضة، والتي لم تُرفع بالكامل حتى اليوم رغم وجود قرارات دولية بذلك، لكنها تحتاج إلى إجراءات تقنية قد تستغرق وقتاً غير قصير.
أين تُخلق الوظائف الآن؟
في السياق، يظهر الطلب الفعلي على اليد العاملة اليوم في أنشطة إعادة الإعمار والبنى التحتية والطاقة، وقطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة الآلية، إضافة إلى احتياجات متزايدة في تكنولوجيا الدفع والتحوّل الرقمي مع بدء اتصالات بين المصرف المركزي وشركات دفع دولية.
مشاريع الطاقة التي أُعلن عنها تفتح بوابة لوظائف في البناء والتشغيل والصيانة، بينما تبقى الصناعة التحويلية بحاجةٍ إلى استقرار الطاقة والتوريد لتستعيد قدرتها على التشغيل. لكن العامل الحاسم هو توقيت التنفيذ: العقود الكبرى تتحول إلى وظائف بعد إشغال مواقع العمل وتوفير التمويل والقطع والتجهيزات المحلية، أمور لا تحدث بين ليلة وضحاها.
بطالة المتعلّمـين: مشكلة جودة التشغيل
ويُعتبر الخرّيجون الجامعيون والمتعلمين الفئة الأكثر تضرراً إذ يجتمع فيها عنصران: فائض العرض من جهة، والفجوة المهارية والعملية من جهةٍ أخرى، فـأرباب العمل المحليون والدوليون يفضّلون اليوم مهارات عملية: فنيّو صيانة طاقة، مهندسو طاقة متجددة، مختصّو تبريد وتكييف صناعي، وتقنيو بيانات، وغيرها من مهاراتٍ كان معظم التعليم الرسمي في سوريا يفتقر إلى برامجه التدريبية الحديثة لتتهيأ لها. والنتيجة أن نسبة بطالة المتعلّمين تفوق المتوسط العام، وترتبط بخطر هجرة العقول أو انتقال الخريجين إلى سوق العمل غير الرسمي بأجور أقل من مستواهم التعليمي.
فجوة المهارات
ولإغلاق الفجوة يجب ربط الاستثمارات ببرامج تدريبية مكثفة، وإلزاميات تشغيل محلية ضمن عقود إعادة الإعمار، وإنشاء صناديق تمويل صغيرة لتشغيل أنشطةً من قِبل مؤسسات محلية. هذه الآليات ليست رفاهية؛ بل شرط لاستفادة العاملين المتعلمين من السوق الجديدة. وفي غيابها، قد يتحوّل تدفّق رؤوس الأموال إلى مشاريع تعتمد على عمالة أجنبية أو تقنيات مستوردة لا تنقل مهارات للمجتمع المحلي.
في المحصلة، وبالرغم من أن التحوّل الذي شهده الواقع الاقتصادي بعد سقوط النظام قد فتح أبواباً مهمة، لكنّه لم يأتِ بعد بمخرجات كافية لسوق العمل، ولا سيما لطبقة المتعلمين. وعليه، فإن سوق العمل السورية اليوم تقف على مفترق: بين إمكانية إعادة تشغيل جزء مهم من اليد العاملة “في حال صدقت الوعود الاستثمارية”، وبين خطر تضخّم بطالة جديدة وهجرة اقتصادية إذا بقي الواقع الاقتصادي هشاً، فالمعركة ليست فقط على جذب رؤوس المال، بل على تأهيل الكفاءات، وإصلاح البنية، وبناء مؤسسات قادرة على ترجمة الاستثمار إلى عمل.
المصدر: المدن